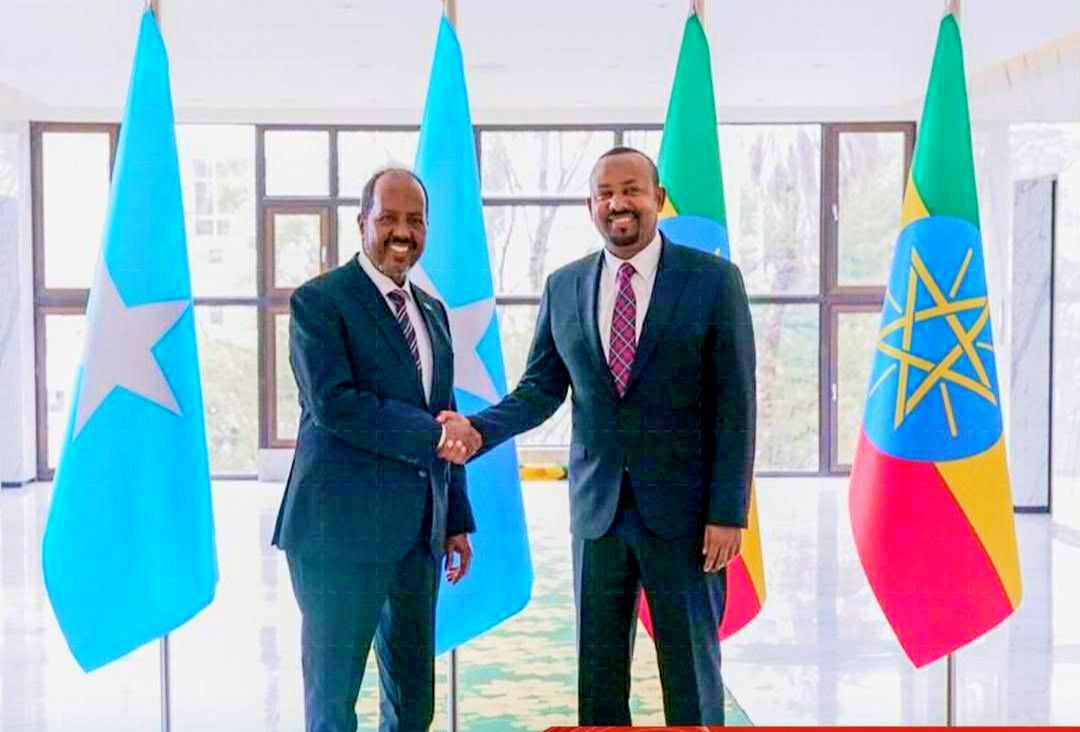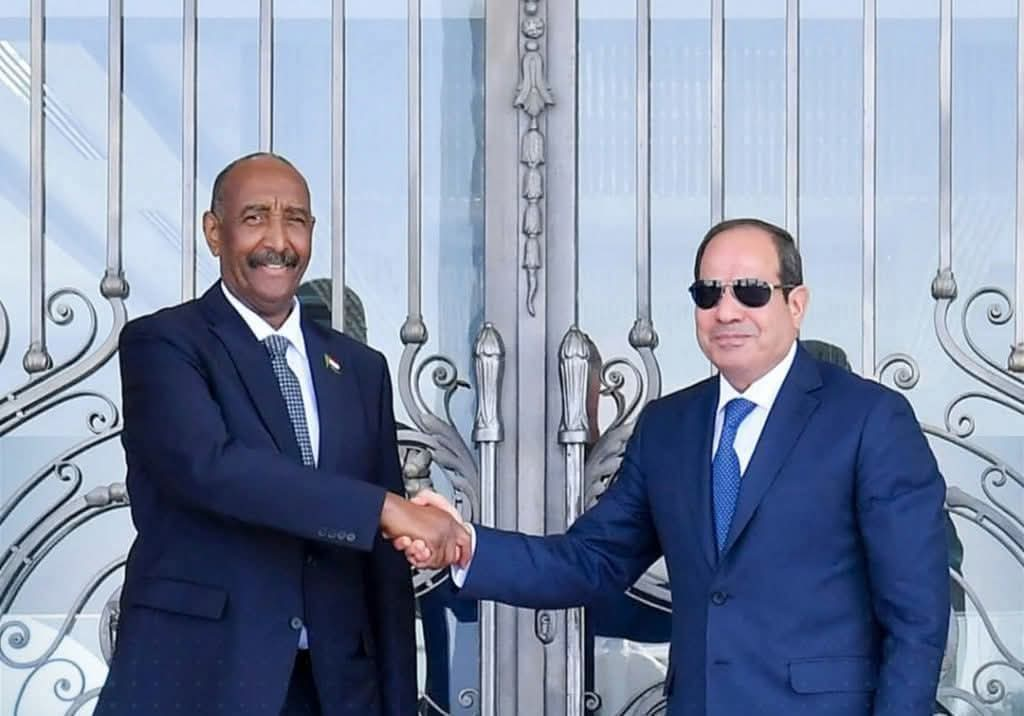عبدالحى عطوان يكتب: (الجزء الثاني) حين اشتدَّ الطريق بين القلب والقدر

عاد إلى القرية عند المساء، هائمَ الخطى، يحمل في يده شهادةً انتزعها من عمره انتزاعًا، وفي صدره حلمًا لم يبرح موضعه منذ اللحظات الأولى لخفقان قلبه. كانت الطريق مألوفة، لكن كل خطوة تقرّبه من المكان كانت تُعيد إليه ارتباكًا قديمًا، كأن الذاكرة قد سبقت الجسد ووصلت قبله.
أحلامٌ كثيرة وأفكارٌ تساوره، تتجسّد ملامحها في نظرات عينيها وابتسامتها التي يخفق لها قلبه.
بدأت ملامح بيوت القرية تتلألأ تحت ضوء القمر، غير أنه لم يرَ منها سوى بيتٍ واحد… بيت الشيخ مصطفى. وهناك، خلف نافذةٍ ضيقة، تقيم صباح، وتُقيم معها أحلامه المؤجلة. مرّ بمحاذاة البيت ببطءٍ بالغ، وكأن قدميه قد خانتاه، أو كأن الخوف قد شدّهما إلى الأرض. رفع رأسه على استحياء، فالتقت عيناه بعينيها. كانت واقفة عند النافذة، ينساب الفرح من نظرتها، ويغمر الحياء وجنتيها. رفعت يدها بإيماءةٍ خفيفة، لكنها كانت كافية لأن تُربك كل شيءٍ في داخله. لوّح بإحدى يديه وبرأسه، مكتفيًا بابتسامةٍ صامتة دون حديث، ثم مضى، وقد أدرك أن ساعة المواجهة لم تعد مؤجلة.
في صباح اليوم التالي، وبينما كان يتهيأ لما عقد عليه العزم، سرَت في القرية همساتٌ ثقيلة، تتناقلها الألسن بنبرةٍ مشوبة باليقين:
إن الشيخ مصطفى قرر تزويج ابنته لابن أخيه المقيم في العاصمة؛ مهندس مستقر، ميسور الحال، مكتمل الأسباب، قادر على أن يمنحها حياةً لا يهددها العوز.
وقعت الكلمات عليه كما يقع الليل على مدينةٍ بلا مصابيح. تلاشت معالم الأشياء من حوله، وبهتت الألوان، وتداخلت الأصوات، حتى بدا العالم كتلةً واحدة من الصمت والاختناق. تردّد طويلًا، ودارت في رأسه آلاف الأسئلة كطواحين الهواء. كان يعلم صلابة الشيخ مصطفى وتقاليده، والحكايات التي تُروى عنه، لكنه أدرك أن الهروب لن يغيّر من الحقيقة شيئًا.
ومع حلول المساء، مضى إلى بيت الشيخ مصطفى. طرق الباب بثباتٍ حاول أن يستعيره من عقله، فيما كانت يداه ترتجفان. فتح الشيخ الباب، وكانت في عينيه صرامةٌ لا تخلو من معرفةٍ مسبقة بالسبب.
قال، وجسده يكاد ينتفض، محاولًا أن يمنح نفسه التماسك بالجلوس معتدلًا، وبصوتٍ حاول أن يكسوه الوقار:
"جئت أطلب يد ابنتكم، صباح."
لم يحتج الشيخ إلى تفكير. أجابه بحسمٍ جاف، بعدما قدّم له واجب الضيافة وأثنى عليه بالكلمات: إن نصيبها ليس هنا، وقد كُتب لها أن تذهب إلى حيث الاستقرار، إلى ابن أخى مهندس أتمّ بناء حياته.
حاول الطبيب الشاب، وهو يرى حلم عمره ينهار، أن يدافع عن نفسه بهدوء العقل: إن له علمًا ومستقبلًا يصنعه، وما ضاق رزقٌ اتّسع أملًا. لكن الشيخ قطع حديثه، مستندًا إلى عصاه، وقال بنبرةٍ لا تقبل الجدل: إن المشاعر لا تُقيم بيتًا، والزواج حساب قبل أن يكون إحساسًا، وابنتي ليست لك.
وقعت كلمات الجملة الأخيرة عليه أثقل من كل ما سبقها. خرج من أمامه بعدما حاول أن يلطّف الموقف ببعض الجمل، مكتئب الروح، كأن الهواء قد خان رئتيه. جلس على طرف الطريق، رأسه بين يديه، والليل يطبق عليه.
لم يكن يعلم أن صباح كانت تراه من خلف نافذتها، وتتابع انكساره في صمت، ودموعها تنحدر بلا صوت، وهي تشهد الرجل الذي أحبته يغادر مثقلًا بالخذلان.
في تلك الليلة، لم يرَ النعاس جفونه؛ فقد بهتت كل الألوان أمامه، حتى تلاشت خيوط الظلام، ولاح ضوء الفجر معلنًا من الجامع الكبير موعد الصلاة. أدرك لحظتها أن القرار لم يعد مؤجلًا. أدرك أن الاستسلام خيانةٌ للحلم، وأن الطريق، مهما اشتد، لا يُقطع إلا بالسير فيه. قرر أن يعود إلى المدينة، ليبني لنفسه مقامًا يعود به مرفوع الرأس.
قال في سره:
إن لم يكن الحب كافيًا ليُقيم بيتًا، فسأُقيم البيت أولًا بالعمل والصبر والعزيمة والنجاح.
وفي الجهة الأخرى من القرية، أغمضت صباح عينيها وهمست:
إن كان القدر معنا،وكتب الله لنا الحياة سوياً فلن يُفرّقنا الشيخ مصطفى .
وهكذا بدأ الطريق الأصعب…
طريق لا يسلكه القلب وحده،
بل تمهّده الإرادة، ويصقله الصبر، وتُنهيه الأيام.